دار المعالي تُصدر كتاب "إعادة تشغيل" لـ أحمد السوهاجي
- الجمعة 30 مايو 2025
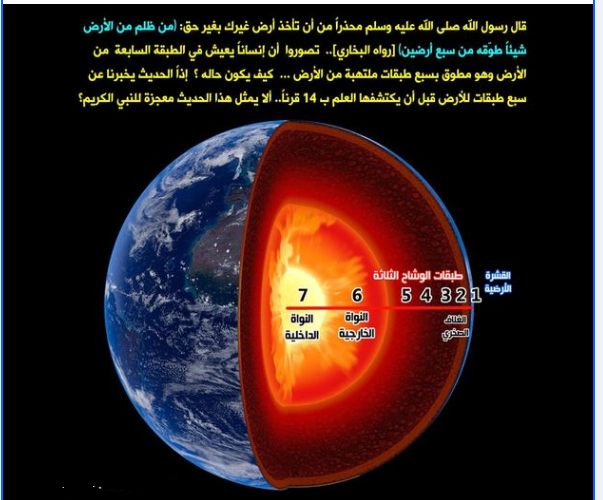
تعبيرية
قال الباحث في الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، الدكتور محمود عبد الله نجا، استاذ بكلية الطب جامعة المنصورة، إنه برغم أن البعض يؤمن بالغيبيات في باب العلم مثل نشأة الكون من المُتفردة (البيضة الكونية)، ونشأة الحياة من خلية بدائية نشأت ذاتياً من الطين، وأكوان متوازية، وأبعاد كثيرة للكون يسكنها عوالم لا نعرف عنها شيء، ولكن عند الحديث عن الله، فنجدهم يُنكروا وجود الله، ويسخروا من المؤمن الذي يؤمن بوجوده، بزعم أن الله غيب لا يمكن رصده بأدوات الرصد المُباشر، وكأنهم استطاعوا النفاذ من الكون المنظور فلم يجدوه.
وتابع: أن هذا الفهم المغلوط
سببه التفسير الخطأ لمعنى الإيمان بالغيب في قول الله (الذين يؤمنون بالغيب)، ثم بسبب
الجهل بطرق الرصد المستعملة لاكتساب المعرفة، فهناك رصد مباشر بالحواس، كما أن هناك
رصد غير مُباشر بالحس العقلي المُصمم سلفاً لاستقراء ما غاب عن الحواس من خلال النظر
والإستدلال، وإليكم التفصيل.
وأردف قائلا: إنه عندما
نرجع لفهم السلف للايمان بالغيب نجد من النادر أن يقول أحدهم أن الإيمان بالله داخل
في معاني الإيمان بالغيب، فكيف يغيب من أدركته البصائر، وقال عن نفسه (وما كنا غائبين)،
وقد ذكر الطبري خمسة أقوال لتفسير الايمان بالغيب ليس منها إلا قولاً واحداً مرجوحاً
ذكر الله في جملة معاني الغيب وهي بالترتيب كالآتي:
1.
عن ابن عباس: بالغيب أي بما جاء من الله
2.
عن ابن عباس وابن مسعود: بالغيب أي ما غابَ عن العباد من جنة ونار, وما ذكر الله في
القرآن.
3.
عن سفيان، عن عاصم, عن زرٍّ, قال: الغيبُ القرآن
4.
عن قتادة: بالغيب أي آمنوا بالجنّة والنار، والبَعْث بعدَ الموت، وبيوم القيامة.
5.
عن الربيع بن أنس: بالغيب أي آمنوا بالله وملائكته ورُسُلِه واليومِ الآخِر، وجَنّته
وناره ولقائه, وبالحياة بعد الموتٌ.
وأكمل: ثم جاء القرطبي
فشرح لنا لماذا ليس الله داخلاً في فهم السلف للإيمان بالغيب فبين أن ذات الله غيب
لا تدركه الأبصار ومع ذلك فهو ليس يغيب عن النظر والاستدلال، قال القرطبي (اختلف المفسرون
في تأويل الغيب فقالت فرقة : الغيب في هذه الآية : الله، وضعفه ابن العربي. وقال آخرون
: القضاء والقدر أو القرآن وما فيه أو ما أخبر به الرسول مما لا تهتدي اليه العقول.
ثم قال القرطبي فالله غائب عن الأبصار ، غير مرئي في هذه الدار ، ولكنه غير غائب بالنظر
والإستدلال......انتهى باختصار).
وأشار إلى ما قاله القرطبي
من ظهور الله بالنظر والاستدلال يوافق أحد معاني اسم الله الظاهر المُشتق من الظهور
أي الذي ظهر للعقول بآثار أفعاله المؤدية للعلم به، فهو ظاهر لأنه مُدرك بالعقول وباطن
لأنه غير مُشاهد بالأبصار، منوها إلى أنه من المعلوم أن أول ما نزل من القرآن لم يكن
الإيمان بالغيب ولكن الأمر باستعمال البصيرة للاستدلال على وجود الخالق، فقال الله
(اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق اﻻنسان من علق)، أي اقرأ يا محمد باسم خالقك الذي أيقنت
وجوده ببصيرتك حال تفكرك في ملكوت السماوات والأرض فأدركت بالنظر والاستدلا من قبل
ان تأتيك رسالة السماء أن الذي صير هذه العلقة إنساناً واعياً عاقلاً سميعاً بصيراً
هو الله الذي خلق كل شيء.
وأوضح أن الأمر بالنظر
في خلق الإنسان من علق، أو بالنظر في آثار رحمة الله (فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ
اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوتها) دليل على أن البصيرة، وإدراك وجود
خالق للكون لا ينشأ كلاهما بالأديان، وإنما هي أمور مُركبة في العقول، فيولد بها الإنسان
كهداية فطرية، فمن سلمت بصيرته لا يحتاج الى دين ليعلم أن لهذا الكون خالق، والإسلام
ما جاء ليأمر الناس باتباع خالق غيبي لا نراه وانما جاء ليستنطق بصيرة كل انسان ليعبد
الخالق الذي شاهد آثاره بعقله، فالله أبين وأظهر من أن يُجهل، فيُطلب الدليل على وجوده.
قال ابن القيم نقلاً عن شيخه ابن تيمية (كيف يُطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟).
وعن مسألة الرصد غير المباشر
بين العلم والإيمان، قال إنه من المعلوم أن الرصد الغير مباشر بالنظر والإستدلال له
حجيته اليقينية التي لا ينكرها العلم كوسيلة مُتفق عليها لتحصيل الكثير من العلوم المُكتسبة.
ولو شك العقلاء في هذه الآلية لكان الشك في العقل والوجود أولى. فعملياً وعلمياً الرصد
بالأثر (الرصد الغير مباشر)، هو طريق فهم الكثير من ظواهر الكون التي لم تشاهدها الحواس
مُباشرة، مثل الجاذبية، والكهربية، والمغناطيسية، ومكونات الذرة، وغيرها الكثير، وأكتفي
بذكر المثال الآتي؛ من المعلوم أن إكتشاف علماء الفلك لكواكب السماء نادراً ما يعتمد
على الرصد المُباشر بالتلسكوبات لبعدها الشديد وانه يتم رصدها بالنظر والإستدلال بطرق
عديده منها مثلاً (طريقة العبور)، فالكوكب الغير مرئي اذا عبر بين الراصد والنجم الذي
يدور حوله فانه سيحجب بعضاً من ضوء نجمه، فنستنتج ببساطة ان هناك جسم حجب ضوء النجم
بالرغم من أننا لا نرى الكوكب وفقط رصدنا أثره.
وتابع: لقد أصبح الرصد
الغير مباشر أحد أسس البحث التجريبي (Emperical research)
حيث يقوم العلماء بتعريف البحث التجريبي على انه البحث باستخدام الدليل التجريبي كطريق
لتحصيل المعرفة من خلال المشاهدات أو الخبرات المباشرة وغير المباشرة (١، ٢، ٣). بل
ويقولون بصراحة أنه لا يمكن إثبات النظريات العلمية، أي النظريات المتعلقة بالطبيعة
غير القابلة للرصد، عن طريق الاختبار التجريبي المباشر، ولكن يمكن اختبارها بشكل غير
مباشر. ويقولون إن طبيعة هذا الدليل غير المباشر، والعلاقة المنطقية بين الدليل والنظرية،
هي جوهر المنهج العلمي، بينما علمياً السببية هي العلاقة بين حدث يسمى السبب (cause) وحدث آخر يسمى الأثر (effect)، بحيث يكون الحدث الثاني نتيجة للأول. ويشير
هذا المصطلح إلى مجموعة العلاقات السببية التي يمكن ملاحظتها خلال الخبرة اليومية والتي
تستند إليها النظريات العلمية في تفسير الظواهر العلمية. وغالبا السبب (cause) سابق زمناً أو رتبة للأثر (effect) فلا يجوز أن يكون لاحقا للتأثير وإلا ذهب مفهوم
السببية البديهي .
وأوضح أن نفس هذه التعريفات
يستخدمها المؤمن للإستدلال على وجود خالق لهذا الكون، فالأعرابي البسيط الذي لم يدرس
فلسفة العلوم قال (الأثر يدل على المسير، والبَعْرَة تدل على البعير، فسماء ذات أبراجٍ
وأرض ذات فجاج وبحارٌ ذات أمواج ألا تدل على السميع البصير؟، ونفس هذه التعريفات يستخدمها
الله في حديثه للناس، قال تعالى (انظر الى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها)،
فالآية صريحة في الاستدلال على وجود الله بالنظر والإستدلال من خلال البديهة العقلية،
فكل أثر مثل (إحياء الأرض بعد موتها) يدل على مؤثر سابق على الأثر (الله الخالق)،
حيث أن دلالة الحوادث على المُحدِث (سبب الحوادث) دلالة حسية عقلية؛ حسية لأنها مُشاهدة
بالحس، وعقلية لأن العقل يدل على أن كل حادثٍ لا بد له من مُحدِث. فكيف لنا بعد ذلك
أن نكذب البديهة الايمانية حين نظرت للكون واستعملت الرصد الغير مُباشر، ومبدأ السببية
(Causality) فاستدلت ببديع صنع الكون (Creativity) وحسن ضبطه (Fine tuning) وتعقيده الغير قابل للاختزال (Irreducible complexity) على أن له صانع قادر ليس كمثله شيء.
ونوه إلى أنه من المفارقات
العجيبة أن بعض العُقلاء يستعمل مبدأ السببية لفهم ظواهر الكون المختلفة، ولكن إذا
درس سبب ظهور الكون تعطل مبدأ السببية وحلت محله حالة غير علمية تنسب نشأة الكون لذاته
أو للصدفة، في مخالفة صريحة لتعريف مبدأ السبيية، وفي وجوب تقدم المؤثِر على الأثر.
وقد فضح الله سوءة هذا الفكر الباطل بإستعمال فلسفة الحق المُستقرة في البديهة العقلية
فقال تعالى (أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون)، فاستنكر الله على المنكرين لوجوده
أن يقولوا بالخلق من غير شيء، مع أنه لا أثر بلا مؤثر، كما استنكر عليهم أن يجعلوا
المخلوق خالق لأن المخلوق نفسه أثر مُفتقر لسبب خارجي قادر على إيجاده.
وأشار إلى أن حاسة البصيرة
بالنظر والإستدلال تؤكد يقيناً أنه لولا أفعال طرف آخر خارج هذا الوجود غني بذاته غير
مُفتقر لغيره يتصف بالأولية (The
first)
أو أنه مسبب الأسباب (First
of all causes)
ما كان لهذا الوجود أن يظهر، وما كان للانسان أن يسود الأرض ولما تميز عن سواه من الأحياء
بقدراته العقلية التي تؤهله للنظر والاستدل. فالعقل مصمم ليفهم ذاتياً بلا واسطة ان
كل أثر (effect) لابد له من مؤثر (cause)،
وأن سلسلة المؤثرات وان طالت فيستحيل ان تطول الى ما لا نهاية والا لما بدأت الأحداث
ولما كنا نحن جزء منها وما كنت لأكتب ما بين ايديكم الآن.
وأضاف أن علاقة الرصد الغير
مُباشر بالفطرة ، تتمثل في أنه جعل للرصد الغير مباشر قيمته الكبيرة في العلم
التجريبي، هو استناده لقواعد العقل الموثوق بها من النظر والإستدلال اعتماداً على معارفه
الغريزية (الفطرية) التي نولد بها، فمن يُنكر ان الواحد أقل من اإثنين، والقريب غير
البعيد، والقليل غير الكثير، والحاضر غير الغائب، والأثر (effect) لابد له من مؤثر (cause)
فيما يعرف بقانون السببية أوالعلية (Causality)،
إلي غير ذلك من اﻷمثلة البديهية التي ولد بها اإنسان دون حاجة لإكتسابها أو تعلمها
من دنياه، فصارت هذه البديهيات أساس لكل علم مُكتسب.
أعرف أن البعض ممن لهم
معرفة بفلسفة العلوم وكيفية حصول المعرفة (Epistemology)
قد يعترض على ما سبق تقريره من ثقة العلم التجريبي في الرصد الغير مُباشر بالنظر، والإستدلال
القائم على مباديء الفطرة كالسبية، بل وربما نقلوا عن بعض الفلاسفة أقوالاً تطعن في
هذه البديهيات العقلية.