دار المعالي تُصدر كتاب "إعادة تشغيل" لـ أحمد السوهاجي
- الجمعة 30 مايو 2025
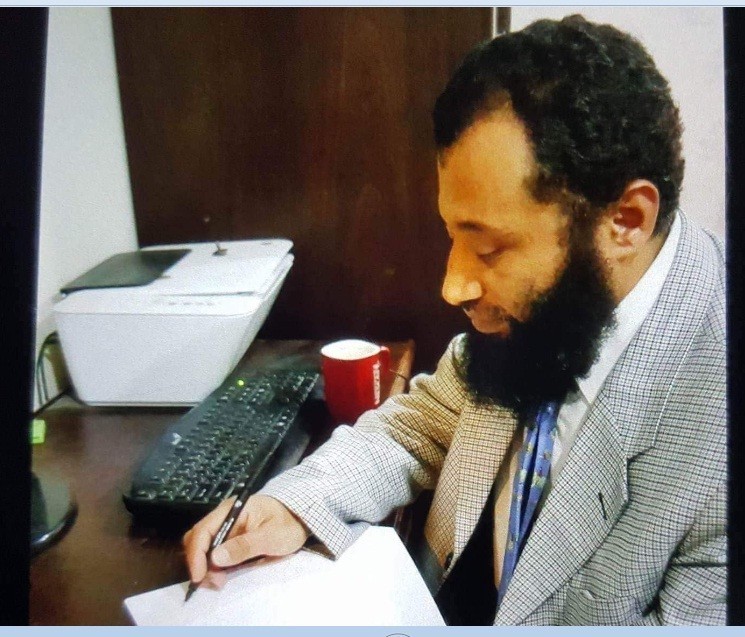
فاضل متولي
ضوابط الإطلاق والتقييد.
من ناحية التصور هناك إطلاق مطلق وإطلاق مقيد
وتقييد مطلق، ويمكن القول بإن التقييد المقيد هو الإطلاق المقيد.
هناك من دعا إلى الإطلاق المطلق: فرأى وجوب
الحرية المطلقة بأن لا يكون على البشر أي قيد من أي نوع ولا قيد الحكم، فصور في
إحدى مسرحياته شابا يرث العرش، وبمجرد استلامه الحكم يختفي تاركا شعبه دون سلطة.
يريد بذلك أن يترك للجماهير الحرية في كل شيء. وهذا مكر أو عفوية تشبه المكر: فما
يسوغ لإنسانا أن يجلس على عرش ليكون حكمه الأوحد هو تعطيل الملك بما يعنيه ذلك من
إطلاق العنان للمحكوم يسوغ لآخر أن يتزيى بزي المفكر أو الفيلسوف ليكون رأيه
وتوجيهه للبشر هو أن ينفضوا أيديهم من كل رأي ويضربوا صفحا عن كل توجيه.
وهناك من دعا إلى الإطلاق المقيد أو على
الأقل كان هذا سلوكه في حياته.
ولا يحضرني أن هناك من دعا إلى التقييد في كل
شيء، ولا أتصور وجوده.
وليس السؤال الآن عن المقاييس التي اعتمد
عليها كل فريق، ولكن السؤال عن المقاييس التي يجب الاعتماد عليها في التقييد أو
الإطلاق؟ هل هي ضوابط ومقاييس إنسانية أم غير إنسانية؟ أم هي من هذا وذاك؟
ولكي نحاول بالعقل الإجابة عن هذا السؤال لا
بد أن نسأل سؤالا آخر:
ماذا يريد الإنسان؟
والسؤال هنا مطلق، أي أن السؤال: ماذا تريد
أيها الإنسان من كل من يمكنه أن يعطيك أو ممن يمكنك أن تأخذ منه؟
ماذا تريد على المدى القريب وعلى المدى
البعيد؟
ماذا تريد أن تفعل فلا ترد عن فعلك؟ وما
غايتك من فعلك؟
لو أن الناس جميعا سئلوا هذه الأسئلة لتباينت
إجاباتهم، ولكن التشابه الذي سيكون بين كل الإجابات أنها هي الشيء الذي يراه
مثاليا سواء رآه أو سمع به أو ربما يطمح قلة من الناس إلى غاية متصورة ممكنة أو
غير ممكنة.
وانتبه إلى قولي: يراه مثاليا، فجمهورية
أفلاطون مثلا هي الصورة المثلى في رأيه وهي نفسها مما جر على أفلاطون قدرا غير
قليل من الهجوم.
ويقول جبران في قصيدته (البلاد المحجوبة):
يا بلاد الفكر يا مهد الألى*** عبدوا الحق
وصلوا للجمال***
فالحلم الأكبر له هو الفكر المشتمل الحق
والجمال. وهي كما ترى كلمات تحتاج في ذاتها إلى بيان؛ فالناس –بحسب ثقافاتهم-
متباينون في تفسير معنى الحق ومعنى الجمال.
ونرجع إلى الأسئلة: هل يمكننا أن نجعل
الإجابة عن هذا السؤال: ماذا تريد. مقياسا لتحديد ما نطلق فيه وما نقيد؟
وهل إذا كان هذا المقياس صالحا فهل هو كاف؟
بمعنى: هل رغبة الإنسان كافية لتحديد ما ينطلق وما يتقيد فيه؟
أم أن هناك مقاييس أخرى منها ما يكون إجابة
عن سؤال: ماذا ينبغي أن يكون؟
والبحث في التوفيق والمقارنة بين ما ينبغي
وما يرغب أو المرغوب والمفروض له وقت آخر أرحب من هذا، ولكن دعنا الآن نسترسل
قليلا في الكلام عن التقييد والإطلاق مع استحضار الرغبة بحيث لا يكون التقييد
والإطلاق عائقين في سبيل الرغبة إذا لم يكونا خادمين لها:
لقد كتب أحد الروائيين رواية تتناول موظفا
شابا دخل يوما على مدير الشركة التي يعمل بها، فما كاد يرى ويلاحظ المكتب والمدير
حتى نسي كل شيء، وملأ كيانه حلم بأن يصبح يوما ساكن هذه الغرفة الوحيد وصاحب
المنصب الرفيع.
وقد تتساوى وقد تختلف مع الكاتب في تصور
قائمة الممكنات التي أتاحها هذا الموظف لنفسه، والواجبات التي ألزم نفسه بها
والممنوعات التي حظرها عليها، ولكنك –بلا شك- ستتفق مع الكاتب ومع غيره في تصور
قائمة بما ألزم به نفسه وقائمة أخرى تشتمل ما منعها عنها، هكذا فعل الكاتب وهكذا
يفعل كل أحد لو كان مكانه أو مكان هذا الموظف. ولا أظنك تقول نعم إذا سألتك:
هل تظن أن هذا الموظف أطلق العنان لكل رغباته
يفعل منها ما يشاء، فهو حر في نومه ويقظته، وهو حر في حضوره وغيابه، وهو حر في جده
ولعبه، وهو حر فيما سوى ذلك؟
ومعنى ذلك كله أن كل إنسان لا يسمح لنفسه
بفعل كل ما يرغب في فعله، بل هو يشد عنان نفسه عن رغبات عدة في سبيل رغبة واحدة أو
رغبات أخرى، إلا إذا كانت الرغبة هي نفسها الرغبة، أي الرغبة هي أن يطلق لنفسه
عنان الرغبة.
والحق إن إطلاق العنان لكل الرغبات فيه
مخاطرة كبيرة ليس المرض أكبر عواقبها المحتملة. بل إن الاسترسال في الرغبة قد يؤدي
في نهاية الأمر إلى تقييدها رغما عن صاحبها.
ومؤدى كل ذلك أن الحياة لا تستقيم لفرد إلا
إذا اشترى بعض رغباته برغبات له أخرى. وبصيغة أخرى لن يستطيع الإنسان إشباع كل
رغباته إذا كانت له غاية ما.
إن الغاية العظمى عندنا نحن المؤمنين هي
الجنة، إنها العالم النموذجي الذي لا يرقى إليه حتى الخيال. إنها العالم الذي تكون
فيه الحياة من الرفاهية والسعة ما لن تحققه التكنولوجيا ولا المناهج الفكرية ولا
مشروعات الفلاسفة والمتفلسفة، إنها متعة الروح، ومتعة الحواس الظاهرة والباطنة،
إنها الحياة بلا منغص حاضر أو مستقبل، إنها الأبدية التي لا يتهددها شيء. إنها
مدينتنا الفاضلة، لكنها ليست خيال أديب ولا نسج متفلسف.
ولكن ماذا لو لم تكن له غاية؟ أو ماذا لو كان
فعله هو الغاية، وإشباع الرغبة هو الغاية؟
عندئذ سيجد هذا من يقيده؛ لأنه سيصطدم عند
إشباع ما يريد بما ينبغي.
والبحث فيما ينبغي مسألة يراها بعضهم أمرا
عسيرا، ويراها بعضهم أمرا يسيرا.
ولكن هناك سؤالا قد يعجب له بعض الناس، لكنه
سؤال يطرح نفسه رغم ادعاء بعض الناس أنه يعرف الجواب:
من الذي يحق له أن يجيب عن هذا السؤال؟
هل هم جميع البشر؟ لو أجري استفتاء بين الناس
طلبا لجواب فهل سيجيب الناس جميعا إجابة واحدة؟
فلو أعطيت كل واحد من سكان الأرض دفترا وطلبت
منه أن يكتب ما ينبغي أن يكون في العموم وله هو خاصة، فهل سيكون الجواب متشابها أم
مختلفا؟
وقد يسأل سائل: وهل ما ينبغي أن يكون ينبغي
أن يشتمل العالم كله أم أنه من الممكن أن يكون لكل أمة ما ينبغي لها وقد لا ينبغي
لغيرها؟
ومرة أخرى أقول: من الذي ينبغي أن يجيب عن
هذا السؤال أيضا: أعني به السؤال عما إذا كان الذي ينبغي أن يكون عاما شاملا
الدنيا كلها أم لكل أمة مفروضات تلزمها ولا تلزم غيرها؟
إن الدول التي تأخذ بنظام الاستفتاء على
القوانين تسمح للمصوت أن يقبل القانون أو يرفضه، لكنها لا تسمح له بقبول بعضه ورفض
البعض، ولا تسمح له أيضا باقتراح أو تعديل لمادة بدلا عن مادة لم يرضها. ولو سمح
لكل واحد من الجماهير باقتراح مادة بديلة أو تعديل في المادة المطروحة للتصويت أو
القبول الجزئي والرفض الجزئي لبعض المواد فلن يكون هذا القانون بعد تمريره جامعا
لكل جوانب وشؤون الحياة، لن يتناول –في الواقع- غير قشرة من قشور الحياة أو قشرة
الحياة، العلاقات الظاهرة بين الجماهير من جهة وبين الجماهير وبين الحاكم من جهة
أخرى. وتبقى شؤون كثيرة من حياة الفرد، خارج كل القوانين.
وقد صنفت مجلدات وحبرت أوراق وأريقت محابر، وقدحت أفكار في الكلام عن غاية
الإنسان من وجهة نظر المفكر الذي يصنف أو يتحدث وعما ينبغي أن يكون استرشادا بهذا
الذي يلتمسه البشر، ولكننا لم نجد قط من المفكرين من يكتنف بفكره كل جوانب الحياة
صغائرها وكبائرها. كل ما قرأناه نماذج يتعاطاها المثقفون فيعجبون بها أو ينقدونها
فيعجب القارئ والسامع بالناقد أو بالمنقود. فهي إما قاصرة عن ملأ كل فراغ فيما
ينبغي من توجيه الجنس البشري أو على الأقل أمة من الأمم أو فئة من الناس.
هم يحسنون ثيابهم، ويزينون كلامهم ويظهرون ما يبطنون أو ما يبطنون غيره من
أمارات الذوق والكياسة.
هم يعرفون كيف يتكلمون ليأخذوا بألباب السامعين.
فيهم الجريء وفيهم المغامر وفيهم من يأتي بغرائب فاتنة مخادعة.
يعطَون ما يصور وما يخبر ويكبر.
ثم ينصرف الحاضرون وكأنهم ابتلعوا ما يذهلهم عن الظمأ وهم ظماء. يظنون أن
حاجتهم أشبعت، فإذا نظروا إلى أنفسهم لم يجدوا إلا ما سمعوا إن وجدوه.
فأين هو الإنسان الذي ينبغي أن يجيب: ماذا ينبغي أن يكون؟ ومن هو الذي يسأل
عن ذلك؟
ثم إننا لا نجد أحدهم يلقي إلينا بنبت فكره حتى يلقي آخر بغيره، فلو أن كل
الناقمين والشانئين والرافضين لهذا أو ذاك كفوا عن رفضهم واعتراضهم لما ضرهم من
ذلك شيء؛ يكفيهم ضرب هذا لذاك، ودحض هذا لذاك، بل نقد هذا ودحضه ونقده لنفسه حتى
تتدخل قوة يؤمن أفرادها بأحدهم ويستطيعون أن يسوقوا لفرضه قوة أخرى من المغيبين
فيفرضون ما هم عليه على أمة أو أمم بقوة الردع لا بقوة الحق.
ولم يتبينوا بعد: أهذه هي الغاية؟ أهذا هو المنهج؟
ونحن نسأل نفس السؤال، ونضيف إليه: أي هذه هي الغاية وأي هذه هو المنهج؟
ومن الذي له أن يجيب؟
وربما حظرت هذه القوة أي منهج غير ما تبنت، وربما تركت له حق التكلم، وربما
يسرت له منصة وصحيفة وشاشة. ولكن ما يقول يبقى دولة بين عقول ما لها من سواعد. أي
أن القوة هي التي تحكم الفكر، هي التي تحسم الصراع بين الأفكار، وأنت تعلم أن
القوة من حيث كونها قوة ليست صالحة لأن تحكم الفكر ، بل أن الفكر هو الأحق بأن
يحكم القوة.
وقد تقول: حكم الفكر القوة قبل أن تحكمه: وأقول لك يا صاحبي: فلم كان
الأقوياء يطيحون برموز الفكر الذين على كواهلهم صعدوا إلى عروشهم؟ لو كانوا في
قوتهم على إيمانهم لما كان هؤلاء القادة من ضحاياهم. ما نفضوا أيديهم منهم إلا
لأنهم إما نفضوا أيديهم من المنهج الذي استجابوا له أولا أو منعتهم أنفة أو هوى أو
مصلحة مضادة أو ظنهم بعدم حاجتهم إلى أساتذتهم أن يقيموه كما تعلموه وكما أحسنوه
إن كانوا تعلموه وإن كانوا أحسنوه.
وويل للبشر إذا كان لكل فكر قوة تؤازره، وويل لها من التعصب للفكرة لو
تعصبت قوتان، قوتان فقط لفكرتين، لكل فكرة منهما قوة تنصرها بلا ضابط غير التعصب.
ومتى خلا العالم من ذلك. وكيف –ونحن نرى المتصارعين- أن نحكم لأحدهما بأنه الحق ما
دامت هذه رؤية إنسان وهذه رؤية إنسان؟ هل انتصار إحداهما كاف ليدل على صوابها؟ وهل
النصر أمارة كافية للصواب؟ وكيف نحكم إذن قبل الصراع؟ وكيف نحكم إذن إذا لم يكن
صراع؟ وهل يكون النصر علامة للحق فقط أم يكون كذلك علامة على القوة. فكيف ينحسم
الصراع في أنفسنا بين المناهج؟ وكيف ينحسم إذن بين الرؤى؟
المشكلة هي الحيثيات التي تبنى عليها إجابة السؤال:
فمن رأى الإنسان بديلا عن الإله حدد غاية وحدد منهجا، ومن رأى الإنسان شريك
الإله حدد غاية وحدد منهجا، ومن رأى الإنسان خليفة الله حدد غاية وحدد منهجا، ومن
ظن أن الله لا يحق له التدخل في شأن الإنسان من قريب ومن بعيد حدد غاية وحدد
منهجا، ومن رأى أن لله أن يتدخل في ناحية ويخرج من ناحية حدد غاية وحدد منهجا، ومن
أهمل فكرة البحث في وجود أو عدم وجود علاقة بين الله وبين البشر حدد غاية وحدد
منهجا. وكل هؤلاء ساوى –ولو نفاقا- بينه وبين البشر في حق التنظير والتقييد
والتوجيه، وأعطاه الحق في الفرض والافتراض، ثم سلبوا عن الله ما ادعوه لأنفسهم من
حق، وسبحان من صبر على هذا كله، وإن منا من لا يصبر على أهون منه.
فنجم عن إتاحة الفرض والافتراض تناقض حتمي في رؤيتهم لأنفسهم، ومن أمارات
هذا التناقض أن فردا أو شرذمة من الناس يقترفون الفعل فيسخط عليه الساخطون ويجرمه
من له حق التقييم ومن ليس له، فإذا وقعت أمة بأكملها في الإثم نفسه فإذا هم
صامتون؛ لا خوفا على أنفسهم ولكن مباركة لما تفعل.